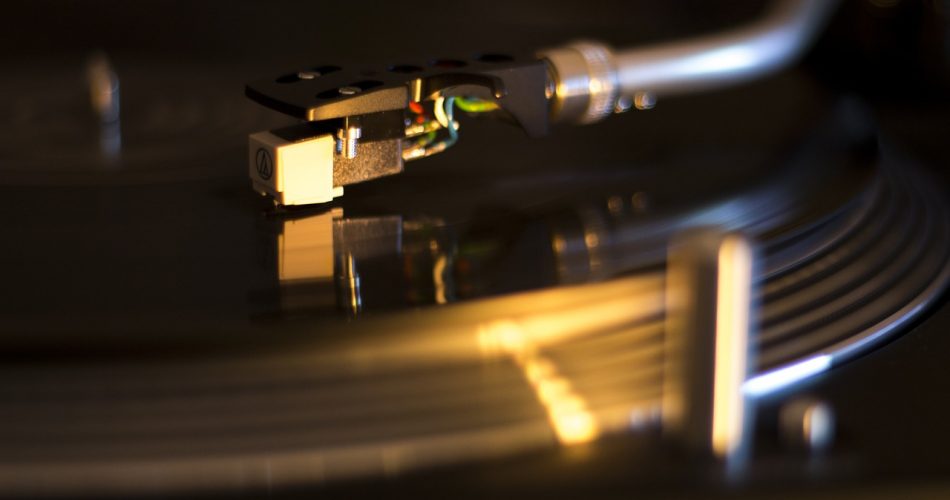إن أقمتَ في العالم فرّ منك كالحلم، وإن رحلتَ حدّد لك القدر المكان، لا الحرُّ ولا البردُّ يمكن التحكم فيهما، وكل ما يزدهر أمام عينيك سيشيخ على الفور ويذبل
جوته
الجزء الثاني
الجمعة وما قبلها من أيام:
السماء صحو كالعادة وصمت مطبق يلف الكون المحيط. أسدل الشال اليمنيَّ بألوانه الزاهية على شاشة التلفزيون. أدير زرّ الموسيقى. أجلس على الطاولة كمن ينتظر أمراً جللاً. وواقع الحال ليس كذلك. ربما الخوف من الكتابة. أو الاطلاع على تفاصيل الحياة المضجرة. حتى الحب والقراءة والبحر تبدو أحياناً أموراً مضجرة (أقول أحياناً لكي تستمر الحياة في نوع من السلاسة واليسر وبعيداً عن التهويل القيامي)، لكنها أفضل الممكنات في غابة هذه الإكراهات المحدقة و(المعولمة) حسب اللفظ المتداول في هذه المرحلة.
دائما تلك الازدواجيّة المرهقة؛ في الليل يدفعنا التعب الى محاولة النوم الكؤود. ليس بسبب نقص مادة (الميلاتونين) في الغدة الصنوبرية للدماغ، تلك التي دعاها ديكارت بمركز الروح وفنّد خطأه لاحقاً، وإنما لأسباب أخرى.. نمضي في المحاولة الشاقة كمن يصارع وحوشاً لا مرئيّة، ندحر هواجس الموت المحتشدة كي تلامس عيوننا إشراق صباح آخر. وحين نربح المعركة وإن في شكلها المؤقت، ويأتي الصباح المأمول، نشعر بالقرف وانعدام الغاية وغياب الاندفاعة الحيويّة اللازمة لاستمرار مسيرة الحياة الحقة.
أجلس أمامي كتب وأوراق، وفي الركن سلة الفواكه التي تتبدىّ غارقة في أحلامها ولم تستيقظ على هول العالم بعد. وأتساءل هل ستسقط في دائرة الهول والتوترّ إذا استخدمها فنان أو كاتب في عمله الفني وأعطاها دور البطولة الذي ربما سيضمن لها الخلود. هل ستستريح في واحة الخلود المشكوك في أصل وجوده، إذ تتحول عن طبيعتها الأصليّة، المألوفة في القضْم والابتلاع؟ أم من الأفضل لها أن تبقى في السلة حتى تتعفّن وتتلاشى؟
وتبعاً لهذه الخواطر، هل نحن البشر، لو شهدنا نوعاً من التحوّل الجذري، في الوسائل والغايات ومجمل العناصر التي ينبني عليها أسُّ وجودنا، وطرائق الحياة والموت، سنكون أقل ألماً، وربما أقرب إلى ضفاف سعادة ممكنة؟
مثل هذه الأسئلة ومشتقاتها، حتى لو لم تكن تعني شيئاً، فهي نوع من رياضة ذهنيّة. لعبة شطرنج مسلّية.
أرفع رأسي عن الورقة، أرى الشال ذا الألوان الأنيقة قد انزاح قليلاً عن جانب من الشاشة التلفزيونية، المغروزة في الأعماق الخشبيّة للمكتبة وقد استقّر عليها مالك الحزين وببغاء ملونة مع أصداف بَحريّة تنضحُ موسيقى وعذوبة، فبدأ المشهد بكامله في بهاء امرأة ريفية ترفع مئزرها في لحظة غرام.
* * *
ألتقي بحسين العبري، في مقهى (ستاربكس).. أخذنا طاولة تطل على باب المطعم المكسيكي، الذي ليس فيه من المكسيك إلا بعض التمائم الفلكلوريّة المعلّقة على الجدران، وطباخه العجوز المفرط السمنة، والذي كان جاري في العمارة السابقة، حين كنت أراه كل صباح، يزرع ويسقي حديقة الدور الأرضي بعناية وإبداع حملاني على كتابة قصيدة نُشرت في (الجندي الذي رأى الطائر في نومه).
حسين يتحدث عن كندا التي رجع منها حديثاً، وبصفته طبيباً نفسياً وروائياً، يحلل الأشياء والعالم من أفق المعرفة النفسيّة.
أردت أن أقترح عليه تحليل سيكولوجية الجبال ومحاولة استقصاء كهوفها ومخابئها المفْعَمة بالأسرار والمهابة الروحيّة. وبما يمكن أن نطلق عليه؛ علم نفس الأزل، علم جمال القسْوة، خاصة إذا عرفنا ان حسين ولد في (الحمراء) على سفح أعتى مركز جبلي في العالم.
مرة ذهبتُ إلى قمة جبل شمس، أعلى الذرى الجبليّة الحائمة هناك. وما هالني من هذه الشوامخ أكثر، هو ذلك (الصَدْع) الذي يشطر الجبل من القاعدة حتى القمّة، مخترقاً كذاكرة جرح حفرتها جحافل السنوات في أعماق جسده العملاق.
* * *
كان بعض قدماء اليمنييّن، أسلافنا، وهم الفرسان البواسل الذين بنوا الممالك والإمبراطوريات بحدِّ السيف- من فرط خوفهم الذي يصل حدّ الخشية والخشوع للجبال. كانوا يعبدون تلك الرواسي الشاهقة، ويستسقونها أوقات الجفاف. ويطلبون منها الرحمة والمساندة في أزمنة الحروب.
كانت الجبال بالنسبة لهم التجليِّ الإلهي الأكثر خطورة على الأرض، لذلك فهي جديرة بكل ذلك التمجيد والتقديس.
علماء الجيولوجيا يقولون أن ما خفي من الجبال في باطن الأرض أكثر مما ظهر.
كم هي متجذرة، صلْبة وضاربة في الأغوار النائية للكون، أمام سطحيّة الكائن البشريّ المدعي، في عبوره المزعج على الأرض.
هل يمكن تخيَلَ غضبها الجارف وهي ترقب منذ قرون ضوئيّة تلك المجزرة البشريّة المشينة عبر التاريخ، أن تزحف كما في الأساطير البابليّة، وعلى قمة من قممها زعيم الآلهة (مردوخ) ذو الأربعين وجه، المطلق القوة والبطش، يرغي ويزبد حاملاً فوق كتفيه الزلازل والطوفانات؟
هل سيكون هذا الزحف الجبلي العاتي، هو النهاية القياميّة الأكثر رأفة من فتك الأسلحة الذريّة؟
لكنّ الجبال ترقب المشهد البشريّ وتذرف الأيام، والدموع التي تسيل في الشِعاب والوديان سيولا رحيمة.
* * *
أشاهد مباراة لكرة القدم، بين من يصفه نقاد الرياضة بفريق الأحلام، وهذه التسمية هي التي شدتني للانحياز إليه (الحلم والخيال وإلا فالهلاك الحتمي) أكثر من شهرة نجومه وسطوتهم في عالم الكرة- وبين فريق برشلونة، غريمه التقليدي.
من الصفر تقريباً، استطعتُ أن أكوّن بعض ثقافة في عالم هذه اللعبة الممتعة، التي يُفرغ البشر فيها حمولة عنفهم في ساحة المعركة، من غير دماء وجثث إلا ما ندر. وهذا النادر يأتي كعلامة تذكير، بأن المزاج البشريّ المتجذر في جماليّة العدوان والشرّ، مادة الأدب الأثيرة، لابد أن يرتدّ الى طبيعته الحقيقية.
صارت لديَّ بعض ثقافة في هذا الاتجاه من كثرة ما أشاهد من مباريات في الفترة الأخيرة؛ أتذكر حين ذهبتُ ذات مرة لجلب الكرة التي ذهبتْ بعيداً خارج الملعب ولم أعد حتى هذه اللحظة التي أشاهد فيها مباراة الفريقين الاسبانييّن.
تركتُ الكرة واللاعبين ينتظرون خمسة وعشرين عاماً على الأقل، وهم ينتظرون. أو هكذا أتخيّلهم مسمّرين في ملعب نادي الجزيرة، كالتماثيل الشمعيّة. الأيادي ممتدة والكرة متجمدة في الهواء الراكد للمدينة الكبيرة.
روحهم الرياضيّة بهذا المعنى تشبه روح خوفو والهرم، صلبةً ومتماسكة أمام الأزمنة.
* * *
أمشي على الشاطئ، ألتقي بعجائز، يقود بعضهم الآخر، في حسرة وتهدّج كأنما يكتبون وصاياهم الأخيرة على الرمل.
وثمة فتاة في مطلع العمر، تمشي وحيدة. عزلتها البحريّة تكثِّف من جمال الجسد الحاسر البطن والسِّرة التي تشبه دنوّ نجمة تلثم زبدَ الموج.
فكرتُ، أن هذه السِّرة، آخر ما تبقى من أمل لإنقاذ العالم من هلاك أكيد.
أليس (ديستوفسكي) من قال: الجمال هو المنقذ الأخير للعالم؟
* * *
الطائر الذي يبزغ دائما بعد انبلاج فجر الصحراء، كانوا يسمونه في القرى الخصيبة، طائر (البابو). وحين يغني على فروع الأشجار الباسقة بعذوبة ومرح، يستبشرون بمقدم ضيف، يستبشرون بالقِرى.
الطائر نفسه يقطع الأزمان ويشدو بعد انبلاج فجر الصحراء. على فرع الشجرة اليتيمة أمام نافذتي، مبدداً وحشة الليل وقهر المدينة الكئيبة.
كل ليلة صرتُ أنتظر في رقة وتواضع، هديّة القدر الرحيمة.
* * *
طائر صغير يقفز بين الأغصان بخفة ورشاقة، يسمونه في البلدة التي أضحت مستحيلة، طائر (السنيسلو) كان غالباً ما يتسلَّق غدران الموز وعذوقه أكثر من عذوق النخيل العميقة، حتى كأنها موطنه الأساس وما تبقى أماكن مؤقتة، يخفت فيها زهو حياته ومرحه. لذلك يكون حضوره بين تلك العذوق والأوراق الخضر المتمايلة في النسيم، حضورا طاغياً على غيره من الطيور والحيوات.
وبصوته الأكبر من حجمه وسمارته التي تمنحه جمالاً خاصاً وصفات أخرى يخبئها الصوت والرشاقة.
على الشجرة نفسها التي كان (البابو) يصدح على غصن فجرها الاستوائي، يقفز بين الأغصان والجذوع، وأحياناً على أسلاك الكهرباء التي تخترق فضاء الشجرة، لكنه يعود مرتجفاً الى شجرته كمن شعر بأن تحت قدميه الصغيرتين شيئاً عدوانيّاً وغريباً على كينونته وطبيعته الأصليّتين.
* * *
»وإني وإن كنتُ الأخير زمانُه
لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل«
بيت يجري مجرى المثل لدى السذّج والدهماء. لكنه لا يليق بأعمى المعرّة وضوء بصيرتها الأوحد، ولا بمنزلته الفلسفيّة والشعريّة. إنه أقرب الى عسكري معتوه بطموحه الفج. أو بعدّاء ينزع الى تحطيم الأرقام القياسيّة. أو بملاكم.
المعري يسلبنا اللبّ ويستحوذ علينا حين يسكن متْنَه، بيت سلالته المتورطة في عرين الحكمة المرّة، وفي بؤرة الخطر الحقيقيّة كما في هذا البيت »الجاهلي«:.
»ما أطيبَ العيش لو أن الفتى حجرٌ
تنبو الحوادث عنه وهو ملموم«
* * *
اليمام يهذي، يكاكئ، يبدع الإيقاع بنغم أحشائه التي تسيل مع الظهيرة في البحر.
اليمام صديق طفولتنا لم يعد يجفل من الفخاخ ونشاشيب الصيد. صار أليفاً، تستطيع لمس ريشه النديِّ. صار أقل إحساساً بالغدر والافتراس. ربما لأن ليس هناك من طفولة شقيّة صاخبةً في هذه البطاح.
* * *
قادماً من زيارة لبعض الاخوة في منطقة (الحيْل) يبدو أن لا زيارة قريبة (لسرور)، رغم أطياف العواطف الموغلة في القِدم، التي تلاحقني باستمرار. (سرور) التي قبرتُها في قلبي مثلما قبرتْ في أحشائها أبي وأمي، ومن قبلُ ومن بعدُ، ربما رأفةً بهم من معايشة انحطاط هذا العالم.
أتذكر حين زرتها (سرور) منذ عام، وكانت الوالدة، ما تزال على قيد الحياة الصعب. بنظرها الضعيف تتحرك وسط حفيف أشجار النخيل والموز التي يوشك المحل أن يسحقها بالكامل؛ وأزيز حشرات الجدران المتهاوية للمنزل القديم وكأنما أزيز الأزمنة المتراكمة.
كان الصِبية، أحفادها، غارقين في الفوضى والصراخ…
وأولئك العابرون من غير أمل، بملابسهم الرثّة ووجوههم الغائرة كأنما تفصلهم عن بلاد النفط مسافات ضوئية، كأنما قدموا من كوكب آخر.
هناك في (الحيل) وجدت في باحة الدار، بعض الأطفال يقودهم عمر بن سليمان، ذلك الطفل الذي يتقدم عمره ذكاءَ وخيالاً. أول ما وصلت واستقبلني على باب السيارة، قال، انه لا يريد مني (فلوساً) هذا اليوم، وإنما يود اصطحابي لمشاهدة أعشاش العصافير واليمام في باحة الدار الخلفيّة التي تطل على وادٍ سحيق جاف. باحة الدار كانت مدروزة بالنخيل وأشجار أخرى متفرقة، تغالب مقدم الصيف الحارق.
نظرت إلى أعلى، فرأيت عشَّ عصافير يتدّلى قريباً، ويمكن لمسه عبر رافعة صغيرة.
كان العش الصغير المنسوج بإتقان مدهش في بساطته الجماليّة، وحبكته التي لا تستطيعها عقلانيّة المصانع الحديثة، يدخر في حناياه كل دفء وحنان العالم.. ترى الصيصان داخله، تفتح عيونها، التي ما زالت ترى النور لتوّها، وتغمضها في هدوء وسلام كأنهما الأبديّة.. الأبديّة تتثاءب في عشِّ عصافير.
صار عُمر، يخبط الرافعة تحت قدميّ، محذراً من لمس العصافير الصغيرة بسوء. هو الذي لا يتوانى في وقت آخر من بعثرتها وسحقها (بنشّاب) صنعه بنفسه مثلما كنا نفعل في الأزمنة الماضية.
سألته عن المدرسة التي لا يعيرها أهميّة، تتناسب مع فطنته المبكرة، فردّ بعدم اهتمام، ان علاماته هذا العام جيدة. لكنه لو نجح وتفوق فهل يجد عملاً مثلما عليه الحال لدى بعض اخوته وأبناء عمومته؟
كان عمر في بعض الأوقات يفقد مرحه وحيويّته المنفلتة من أي قيد كأنما صاعق يُخمد تلك الجذوة الصغيرة المتّقدة في أعماقه، يحصل ذلك ليس لأسباب معنويّة، وإنما لتعرضه لنوبات من الصَرَع الخفيف التي تذهب به الى ما يشبه الغيبوبة والهمود.
ربما ورث ذلك من أبيه الذي تراوده نوبات صَرَع عنيفة، يظلّ يرتجف كمن صُعق بماس كهربائي، أو أصيب بطَلْق ناري مفاجئ وغادر؛ فيغرق البيت كله في جو جنائزي مخيف.
حين رجعتُ (أواخر الثمانينيات) بعد انقطاع طويل، نزلت في بيته بمنطقة (وادي عدي) تلك الحفرة الغائصة بين براثن الجبال.
شاهدتُه يسقط صريعاً والزبدُ يتدفّق من أطراف فمه. وتخيلتُ بنات آوى ينفجرن نائحات في كهوف الجبال المحيطة ليكون المشهد على ذلك النحو من القتامة والرهبة.
استعدت، ليس ما قرأته في الأدب حول نوبات الصَرَع، وإنما ذلك الحدث، حين كنتُ في سرور، في أحد الأصياف البعيدة، رأيت في عزّ الظهيرة رجلاً يتداعى ساقطاً في مياه الفلج الغزيرة. ويظل يرفس، كالمذبوح في دوامة المياه.
* * *
حين رجعت من (الحيل) اتصلت بيحيى المنذري بغية أن أراه في هذا اليوم. قال: أين أنت الآن؟ أجبتُه، قريباً من (وقبة الصاروج) فانفجر ضاحكاً هو الذي لا تخرج منه الضحكة إلا غِلاباً.. وهكذا انتهيت، إلا أنني، قلت، لا شعورياَ (وقبة) شيشة البنزين!!
الوقبة ، ذلك المفصل البارز في مسار الأفلاج، التي يستقي منها البشر والحيوانات، وهذه تستقي منها السيّارات التي صنعها البشر والعربات. ليواصل الإثنان حياتهما السريعة سرعة سقوط الوعي والمعلوم أمام سطوة اللاوعي والغيب، مهما بعدت المسافة وشطّت في الزمان والمكان.
يمكن لإنسان، أن يتخيّل، في صباحات المدن الكبرى بعد سهرة صاخبة، أن ساحات تلك المدن، مثل ساحة (الكونكورد) مثلاً أو ساحة (الطرف الأغر)، (حلقة) أو هبطة كبيرة، من تلك التي تنعقد في مناسبات الأعياد. وأن الثيران السمينة الهائجة والأبقار والحمير والأغنام والدلاّلين الذين يحتقن بأصواتهم الفضاء، هي نفسها العناصر والأصوات التي تؤثث تلك الأمكنة.
هكذا، بخفة تسري في الضلوع، بضربة »اللاوعي« الرابضة في الخفاء، ينقلب المشهد على نحو فنطازي دال أيّما دلالة على ترسب الانسان الأول وتحجّره في الأعماق الدفينة للكائن، وهو يعاود الظهور والانتصار على إنسان الحداثة والتكنولوجيا الذي صنعته وسوّقته الأزمنة اللاحقة.
* * *
ذهب انتونان آرتو، الى المكسيك بحثاً عن فكرة جديدة للإنسان.
وهناك وسط حطام الأساطير وعنف الآلهة الدمويّة والفراغ.
وسط الركام الآخذ في التصاعد لنفايات الثقافة الغربيّة التي هرب من براثن رؤاها وقيمها الشاعر، أسوة بأسلافه الهاربين، نحو الشرق، موطن الحكمة والإشراق.
رجع آرتو من رحلته تلك بفكرة جديدة عن خراب الإنسان.